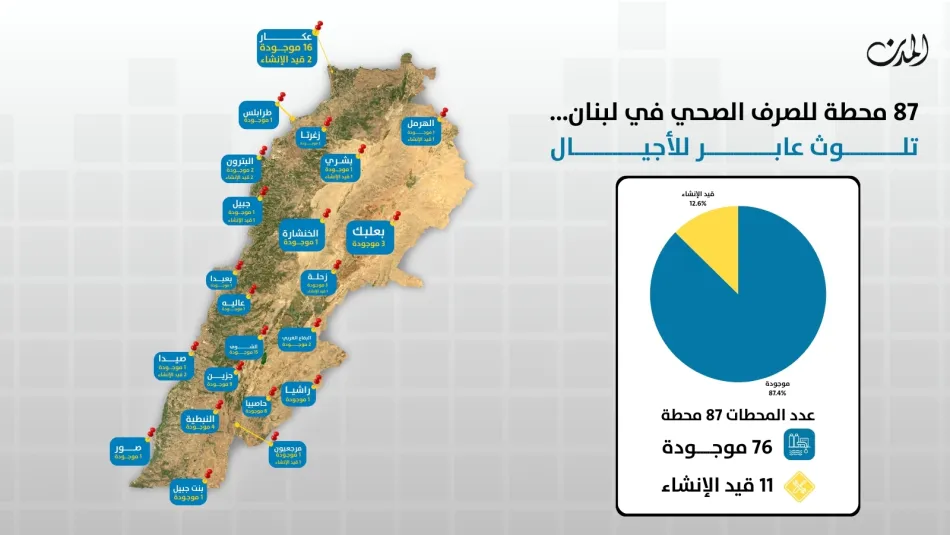“أبو عمر” واحد من سلسلة “الابوات” في تاريخ لبنان

ذكرّتني سردية “أبو عمر” ببيت من قصيدة الشاعر خليل مطران بعنوان “سجدوا لكسرى إذ بدا إجلالا”، وفيه يقول مَا كَانِتِ الْحَسْنَاءُ تَرْفَعُ سِتْرَهَا لَوْ أَنَّ فِي هَذِي الجُمُوعِ رجَالاَ. فكما كان الوضع في بلاد فارس في زمن كسرى وبزرجمهر كذلك هي الحال اليوم في لبنان. فلو كان معظم رجال السياسة في لبنان “على قد الحمل” رغم وجود قلة ينطبق عليها وصف رجال دولة، لما كان “أبو عمر” ولا غيره من الأسماء المستترة قادرون على التغلغل بهذا
الشكل الفاضح في مسام الحياة السياسية بتفاصيلها المقززة والمستفزة لشريحة واسعة من اللبنانيين، الذين كانوا يعتقدون أن بعض السياسيين، الذين يبايعونهم ويسيرون خلفهم، هم فوق الشبهات والصفقات والسمسرات و”ألاعيب الكشاتبين”، ليكتشفوا أن الجميع منازلهم من زجاج.
ليست المشكلة في اسمٍ مستعار، ولا في شخصية غامضة خرجت فجأة إلى الضوء، بل في البيئة السياسية التي سمحت له، ولغيره، بأن يتحولوا إلى لاعبين مؤثرين في لحظات مفصلية من تاريخ البلد. فحين تُدار السياسة بعقلية الصفقات الصغيرة، وحين تُختزل القضايا الوطنية الكبرى بحسابات انتخابية ضيقة أو بمصالح آنية، يصبح من الطبيعي أن يتقدّم “أبو عمر” وأمثاله إلى الواجهة، وأن يتراجع أصحاب القرار الحقيقيون إلى المقاعد الخلفية، متفرجين أو متواطئين.
فالسياسيون، بمعظمهم، لم يعودوا يتعاملون مع التطورات السياسية الخطيرة بوصفها محطات مصيرية تستوجب وضوحًا وشجاعة ومسؤولية وطنية، بل كفرص للمناورة، أو للمقايضة، أو لتحسين شروط التفاوض في “بازار” السلطة المفتوح منذ سنوات. خطابهم مرتجل، مواقفهم رمادية، وقراراتهم مؤجلة إلى حين اتضاح اتجاه الريح الإقليمية أو الدولية، وكأن لبنان محطة ترف يمكن الانتظار في قاعاتها، لا بلدًا ينهار يومًا بعد يوم بفعل أخطاء ارتكبتها أغلبية الطبقة السياسية.
والأخطر من ذلك، أن معظم هذه هؤلاء السياسيين يكتفون غالبًا بإنتاج سرديات للاستهلاك الداخلي، يخدِّرون بها جمهورهم، بدلًا من أن يواجهونه بالحقيقة. يكثرون من الشعارات الكبيرة عن الإصلاح والتغيير، لكنهم يعجزون عن ترجمتها فعلًا سياسيًا جديًا حين تحين ساعة الاختبار. وعندما يُطلب منهم موقف واضح في لحظة مفصلية، يلوذون بالصمت، أو يختبئون خلف بيانات خشبية لا تُغني ولا تُقنع.
هكذا، يصبح المشهد السياسي مسرحًا للعبث فنرى أسماء مستترة، ووسطاء مشبوهون، وقنوات خلفية، ورسائل ملتبسة، فيما القوى السياسية التي تدّعي تمثيل الناس تتصرف وكأنها مجرد شركات مساهمة، همّها الأساسي
الحفاظ على حصتها في السلطة، لا الدفاع عن فكرة الدولة ولا عن كرامة العمل السياسي. وفي ظل هذا الانحدار، لا يعود مستغربًا أن يشعر قسم واسع من اللبنانيين بالاحباط والغضب، بعدما اكتشفوا أن هؤلاء السياسيين، الذين وثقوا بهم ليسوا فوق الشبهات، بل غارقون حتى أذنيهم في منطق الصفقات و”ألاعيب الكشّاتبين”.
المسألة، في جوهرها، ليست أزمة أشخاص، بل أزمة رجال سياسة. أزمة شجاعة في اتخاذ القرار، وأزمة صدق مع الناس، وأزمة أخلاق سياسية قبل أي شيء آخر.
فكم من “أبو عمر” يختبئ خلف فقاعات الصابون السياسي، وكم من سياسي يختبئ خلف وجوه مستعارة وموروثة من زمن الوصايات؟ وهل ينتظر اللبنانيون بعد كل هذا أن يبقوا مغشوشين إلى درجة تصديق ما يُرّوج من شعارات بدت عند أول امتحان ثقة بأنها مغطاة بقشرة اسمها “أبو عمر”.
قد يبدو هذا الكلام بما فيه من حقيقة جارحة بالنسبة إلى بعض الذين ارتسمت حولهم الشبهات والاتهامات، التي تبقى مجرد اتهامات ما لم يفرز القضاء الخيط الأبيض عن الخيط الأسود. وإذا لم يفعل القضاء المعني ما عليه أن يفعله لجلاء الحقيقة أمام جميع اللبنانيين فإنه يُخشى أن يصبح في كل زاوية من زوايا حياتنا السياسية أكثر من “أبو عمر” واحد.
“أبو عمر” واحد من سلسلة “الابوات” في تاريخ لبنان

ذكرّتني سردية “أبو عمر” ببيت من قصيدة الشاعر خليل مطران بعنوان “سجدوا لكسرى إذ بدا إجلالا”، وفيه يقول مَا كَانِتِ الْحَسْنَاءُ تَرْفَعُ سِتْرَهَا لَوْ أَنَّ فِي هَذِي الجُمُوعِ رجَالاَ. فكما كان الوضع في بلاد فارس في زمن كسرى وبزرجمهر كذلك هي الحال اليوم في لبنان. فلو كان معظم رجال السياسة في لبنان “على قد الحمل” رغم وجود قلة ينطبق عليها وصف رجال دولة، لما كان “أبو عمر” ولا غيره من الأسماء المستترة قادرون على التغلغل بهذا
الشكل الفاضح في مسام الحياة السياسية بتفاصيلها المقززة والمستفزة لشريحة واسعة من اللبنانيين، الذين كانوا يعتقدون أن بعض السياسيين، الذين يبايعونهم ويسيرون خلفهم، هم فوق الشبهات والصفقات والسمسرات و”ألاعيب الكشاتبين”، ليكتشفوا أن الجميع منازلهم من زجاج.
ليست المشكلة في اسمٍ مستعار، ولا في شخصية غامضة خرجت فجأة إلى الضوء، بل في البيئة السياسية التي سمحت له، ولغيره، بأن يتحولوا إلى لاعبين مؤثرين في لحظات مفصلية من تاريخ البلد. فحين تُدار السياسة بعقلية الصفقات الصغيرة، وحين تُختزل القضايا الوطنية الكبرى بحسابات انتخابية ضيقة أو بمصالح آنية، يصبح من الطبيعي أن يتقدّم “أبو عمر” وأمثاله إلى الواجهة، وأن يتراجع أصحاب القرار الحقيقيون إلى المقاعد الخلفية، متفرجين أو متواطئين.
فالسياسيون، بمعظمهم، لم يعودوا يتعاملون مع التطورات السياسية الخطيرة بوصفها محطات مصيرية تستوجب وضوحًا وشجاعة ومسؤولية وطنية، بل كفرص للمناورة، أو للمقايضة، أو لتحسين شروط التفاوض في “بازار” السلطة المفتوح منذ سنوات. خطابهم مرتجل، مواقفهم رمادية، وقراراتهم مؤجلة إلى حين اتضاح اتجاه الريح الإقليمية أو الدولية، وكأن لبنان محطة ترف يمكن الانتظار في قاعاتها، لا بلدًا ينهار يومًا بعد يوم بفعل أخطاء ارتكبتها أغلبية الطبقة السياسية.
والأخطر من ذلك، أن معظم هذه هؤلاء السياسيين يكتفون غالبًا بإنتاج سرديات للاستهلاك الداخلي، يخدِّرون بها جمهورهم، بدلًا من أن يواجهونه بالحقيقة. يكثرون من الشعارات الكبيرة عن الإصلاح والتغيير، لكنهم يعجزون عن ترجمتها فعلًا سياسيًا جديًا حين تحين ساعة الاختبار. وعندما يُطلب منهم موقف واضح في لحظة مفصلية، يلوذون بالصمت، أو يختبئون خلف بيانات خشبية لا تُغني ولا تُقنع.
هكذا، يصبح المشهد السياسي مسرحًا للعبث فنرى أسماء مستترة، ووسطاء مشبوهون، وقنوات خلفية، ورسائل ملتبسة، فيما القوى السياسية التي تدّعي تمثيل الناس تتصرف وكأنها مجرد شركات مساهمة، همّها الأساسي
الحفاظ على حصتها في السلطة، لا الدفاع عن فكرة الدولة ولا عن كرامة العمل السياسي. وفي ظل هذا الانحدار، لا يعود مستغربًا أن يشعر قسم واسع من اللبنانيين بالاحباط والغضب، بعدما اكتشفوا أن هؤلاء السياسيين، الذين وثقوا بهم ليسوا فوق الشبهات، بل غارقون حتى أذنيهم في منطق الصفقات و”ألاعيب الكشّاتبين”.
المسألة، في جوهرها، ليست أزمة أشخاص، بل أزمة رجال سياسة. أزمة شجاعة في اتخاذ القرار، وأزمة صدق مع الناس، وأزمة أخلاق سياسية قبل أي شيء آخر.
فكم من “أبو عمر” يختبئ خلف فقاعات الصابون السياسي، وكم من سياسي يختبئ خلف وجوه مستعارة وموروثة من زمن الوصايات؟ وهل ينتظر اللبنانيون بعد كل هذا أن يبقوا مغشوشين إلى درجة تصديق ما يُرّوج من شعارات بدت عند أول امتحان ثقة بأنها مغطاة بقشرة اسمها “أبو عمر”.
قد يبدو هذا الكلام بما فيه من حقيقة جارحة بالنسبة إلى بعض الذين ارتسمت حولهم الشبهات والاتهامات، التي تبقى مجرد اتهامات ما لم يفرز القضاء الخيط الأبيض عن الخيط الأسود. وإذا لم يفعل القضاء المعني ما عليه أن يفعله لجلاء الحقيقة أمام جميع اللبنانيين فإنه يُخشى أن يصبح في كل زاوية من زوايا حياتنا السياسية أكثر من “أبو عمر” واحد.