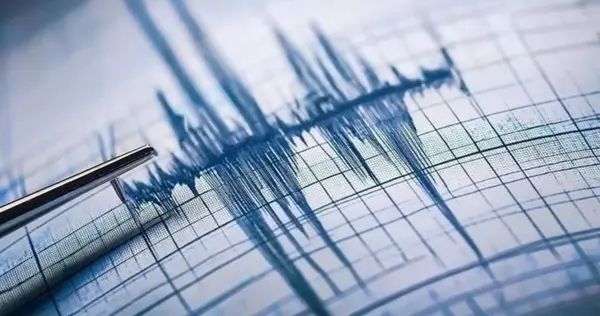كيف تغيّر الدور الأميركي على الساحة الدولية؟

لا يختصر الفرق بين المقاربتين الاستراتيجيتين الدفاعيتين الأميركيتين بين إدارتي الرئيس السابق جو بايدن والرئيس الحالي دونالد ترامب، تبدّل المفردات أو العناوين، بل يعكس تحوّلًا أعمق في فلسفة الأمن القومي الأميركي، وفي الطريقة التي ترى بها واشنطن دورها في النظام الدولي وحدود التزاماتها تجاه الحلفاء والمؤسسات القائمة.
اختارت إدارة بايدن مقاربة قائمة على ما سُمّي الردع المتكامل، أي حماية النظام الدولي القائم على القواعد من خلال تعزيز الشراكات الإقليمية ودمج القوة العسكرية بالأدوات الدبلوماسية والمؤسساتية. لم يكن الهدف خوض مواجهات مباشرة مع الخصوم، بل احتواء التحديات عبر شبكة تحالفات واسعة تُبقي ميزان القوة مضبوطًا من دون انفجار.
وقد تجلّى هذا النهج بوضوح في الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث دعمت واشنطن كييف عسكريًا واستخباراتيًا ضمن إطار تحالفي شمل حلف “الناتو” والاتحاد الأوروبي، مع الحرص على عدم الانزلاق إلى مواجهة مباشرة مع موسكو. المقاربة نفسها انسحبت على التنافس مع الصين، عبر تفعيل أطر إقليمية مثل “كواد” و”أوكوس”، باعتبار أن الاحتواء الجماعي أكثر فاعلية من التصعيد العسكري المباشر. أما في الشرق الأوسط، فحاولت الإدارة الأميركية تقليص حضورها العسكري، مع الإبقاء على دورها كضابط إيقاع يمنع الانفجارات الكبرى ويحافظ على قنوات التواصل.
في المقابل، تعكس ملامح استراتيجية إدارة ترامب، انتقالًا واضحًا نحو مقاربة أكثر صلابة وبراغماتية. اللغة هنا أقل دبلوماسية وأكثر مباشرة: الحسم العسكري، تقاسم الأعباء، الدعم المشروط، والقوة الرادعة. إنه تحوّل من منطق الشراكة المفتوحة إلى واقعية عملياتية تُقاس فيها التحالفات والمؤسسات بمدى خدمتها المباشرة للمصلحة الأميركية.
ويبرز هذا التحوّل في ملفات عدّة أو طروحات، آخرها في الطرح المتعلّق بإنشاء “مجلس السلام” الخاص بغزة، كإطار بديل أو موازٍ للأمم المتحدة. فرغم نفي الرئيس ترامب أن يكون الهدف استبدال المنظمة الدولية، إلّا أن الفكرة بحد ذاتها تعكس نزعة واضحة لتجاوز الآليات الأممية التقليدية، التي لطالما انتقدها واعتبرها بطيئة وعاجزة. في هذا السياق، لا يُطرح المجلس كحل ظرفي لأزمة محدّدة، بل كمؤشر على انتقال أوسع نحو هياكل بديلة تقودها الولايات المتحدة خارج المظلّة الأممية، وبعيدًا من منطق التوافق الدولي.
المنطق نفسه يتجلّى بوضوح في ملف فنزويلا ورئيسها المخلوع نيكولاس مادورو. فبعد مرحلة من التهديدات العلنية والتصعيد السياسي، عاد الخطاب الأميركي ليتبدّل تكتيكيًا عند الحاجة، قبل أن تعود واشنطن وتلجأ إلى خطوات أمنية مباشرة، تمثلت في عملية خطف واحتجاز استهدفت مادورو وزوجته. وفي موازاة ذلك، أعلنت الإدارة الأميركية على لسان وزير خارجيتها ماركو روبيو بشكل صريح أن المصالح الأميركية تأتي فوق كل اعتبار، حتى ولو تعارض ذلك مع الأعراف الدبلوماسية أو الأطر القانونية الدولية. هذا النموذج يعكس مقاربة لا ترى في التهديد والتراجع تناقضًا، بل أدوات متكاملة تُستخدم وفق ما تقتضيه المصلحة.
أما في الشرق الأوسط، فتتجه المقاربة الجديدة نحو دعم انتقائي وسريع، قائم على عمليات نوعية وحسم عسكري، بدل الانخراط في إدارة أزمات طويلة الأمد. ويتجلّى ذلك بوضوح في التعاطي مع الملف الإيراني، حيث لم يعد الخيار العسكري مجرّد أداة ردع نظرية، بل أصبح احتمالًا عمليًا مطروحًا، كما ظهر في سيناريو “حرب الـ 12 يومًا”، الذي جرى تداوله في الأوساط العسكرية كمواجهة محدودة زمنيًا، تُستخدم فيها ضربات دقيقة ومركّزة لفرض وقائع جديدة من دون الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة. في هذا السياق، تُقدّم القوة العسكرية كوسيلة حسم سريعة تهدف إلى تعديل سلوك طهران، لا إلى إدارة نزاع مفتوح أو الدخول في مسار تفاوضي طويل الأمد.
الخلاصة أن الفارق بين استراتيجيتي إدارتي بايدن وترامب، لا يكمن في اللغة وحدها، بل في الرؤية. الأولى تنطلق من فكرة الحفاظ على النظام الدولي عبر الشراكات والمؤسسات، فيما تنظر الثانية إلى العالم كساحة تنافس مفتوحة تُدار بالقوة، وتُعاد صياغة قواعدها عند الحاجة. وبين الردع المتكامل والقوة الرادعة، تعيد الولايات المتحدة رسم دورها العالمي من قائد توافقي إلى لاعب أول يفرض إيقاعه، ولو جاء ذلك على حساب المنظومة الدولية القائمة.
كيف تغيّر الدور الأميركي على الساحة الدولية؟

لا يختصر الفرق بين المقاربتين الاستراتيجيتين الدفاعيتين الأميركيتين بين إدارتي الرئيس السابق جو بايدن والرئيس الحالي دونالد ترامب، تبدّل المفردات أو العناوين، بل يعكس تحوّلًا أعمق في فلسفة الأمن القومي الأميركي، وفي الطريقة التي ترى بها واشنطن دورها في النظام الدولي وحدود التزاماتها تجاه الحلفاء والمؤسسات القائمة.
اختارت إدارة بايدن مقاربة قائمة على ما سُمّي الردع المتكامل، أي حماية النظام الدولي القائم على القواعد من خلال تعزيز الشراكات الإقليمية ودمج القوة العسكرية بالأدوات الدبلوماسية والمؤسساتية. لم يكن الهدف خوض مواجهات مباشرة مع الخصوم، بل احتواء التحديات عبر شبكة تحالفات واسعة تُبقي ميزان القوة مضبوطًا من دون انفجار.
وقد تجلّى هذا النهج بوضوح في الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث دعمت واشنطن كييف عسكريًا واستخباراتيًا ضمن إطار تحالفي شمل حلف “الناتو” والاتحاد الأوروبي، مع الحرص على عدم الانزلاق إلى مواجهة مباشرة مع موسكو. المقاربة نفسها انسحبت على التنافس مع الصين، عبر تفعيل أطر إقليمية مثل “كواد” و”أوكوس”، باعتبار أن الاحتواء الجماعي أكثر فاعلية من التصعيد العسكري المباشر. أما في الشرق الأوسط، فحاولت الإدارة الأميركية تقليص حضورها العسكري، مع الإبقاء على دورها كضابط إيقاع يمنع الانفجارات الكبرى ويحافظ على قنوات التواصل.
في المقابل، تعكس ملامح استراتيجية إدارة ترامب، انتقالًا واضحًا نحو مقاربة أكثر صلابة وبراغماتية. اللغة هنا أقل دبلوماسية وأكثر مباشرة: الحسم العسكري، تقاسم الأعباء، الدعم المشروط، والقوة الرادعة. إنه تحوّل من منطق الشراكة المفتوحة إلى واقعية عملياتية تُقاس فيها التحالفات والمؤسسات بمدى خدمتها المباشرة للمصلحة الأميركية.
ويبرز هذا التحوّل في ملفات عدّة أو طروحات، آخرها في الطرح المتعلّق بإنشاء “مجلس السلام” الخاص بغزة، كإطار بديل أو موازٍ للأمم المتحدة. فرغم نفي الرئيس ترامب أن يكون الهدف استبدال المنظمة الدولية، إلّا أن الفكرة بحد ذاتها تعكس نزعة واضحة لتجاوز الآليات الأممية التقليدية، التي لطالما انتقدها واعتبرها بطيئة وعاجزة. في هذا السياق، لا يُطرح المجلس كحل ظرفي لأزمة محدّدة، بل كمؤشر على انتقال أوسع نحو هياكل بديلة تقودها الولايات المتحدة خارج المظلّة الأممية، وبعيدًا من منطق التوافق الدولي.
المنطق نفسه يتجلّى بوضوح في ملف فنزويلا ورئيسها المخلوع نيكولاس مادورو. فبعد مرحلة من التهديدات العلنية والتصعيد السياسي، عاد الخطاب الأميركي ليتبدّل تكتيكيًا عند الحاجة، قبل أن تعود واشنطن وتلجأ إلى خطوات أمنية مباشرة، تمثلت في عملية خطف واحتجاز استهدفت مادورو وزوجته. وفي موازاة ذلك، أعلنت الإدارة الأميركية على لسان وزير خارجيتها ماركو روبيو بشكل صريح أن المصالح الأميركية تأتي فوق كل اعتبار، حتى ولو تعارض ذلك مع الأعراف الدبلوماسية أو الأطر القانونية الدولية. هذا النموذج يعكس مقاربة لا ترى في التهديد والتراجع تناقضًا، بل أدوات متكاملة تُستخدم وفق ما تقتضيه المصلحة.
أما في الشرق الأوسط، فتتجه المقاربة الجديدة نحو دعم انتقائي وسريع، قائم على عمليات نوعية وحسم عسكري، بدل الانخراط في إدارة أزمات طويلة الأمد. ويتجلّى ذلك بوضوح في التعاطي مع الملف الإيراني، حيث لم يعد الخيار العسكري مجرّد أداة ردع نظرية، بل أصبح احتمالًا عمليًا مطروحًا، كما ظهر في سيناريو “حرب الـ 12 يومًا”، الذي جرى تداوله في الأوساط العسكرية كمواجهة محدودة زمنيًا، تُستخدم فيها ضربات دقيقة ومركّزة لفرض وقائع جديدة من دون الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة. في هذا السياق، تُقدّم القوة العسكرية كوسيلة حسم سريعة تهدف إلى تعديل سلوك طهران، لا إلى إدارة نزاع مفتوح أو الدخول في مسار تفاوضي طويل الأمد.
الخلاصة أن الفارق بين استراتيجيتي إدارتي بايدن وترامب، لا يكمن في اللغة وحدها، بل في الرؤية. الأولى تنطلق من فكرة الحفاظ على النظام الدولي عبر الشراكات والمؤسسات، فيما تنظر الثانية إلى العالم كساحة تنافس مفتوحة تُدار بالقوة، وتُعاد صياغة قواعدها عند الحاجة. وبين الردع المتكامل والقوة الرادعة، تعيد الولايات المتحدة رسم دورها العالمي من قائد توافقي إلى لاعب أول يفرض إيقاعه، ولو جاء ذلك على حساب المنظومة الدولية القائمة.