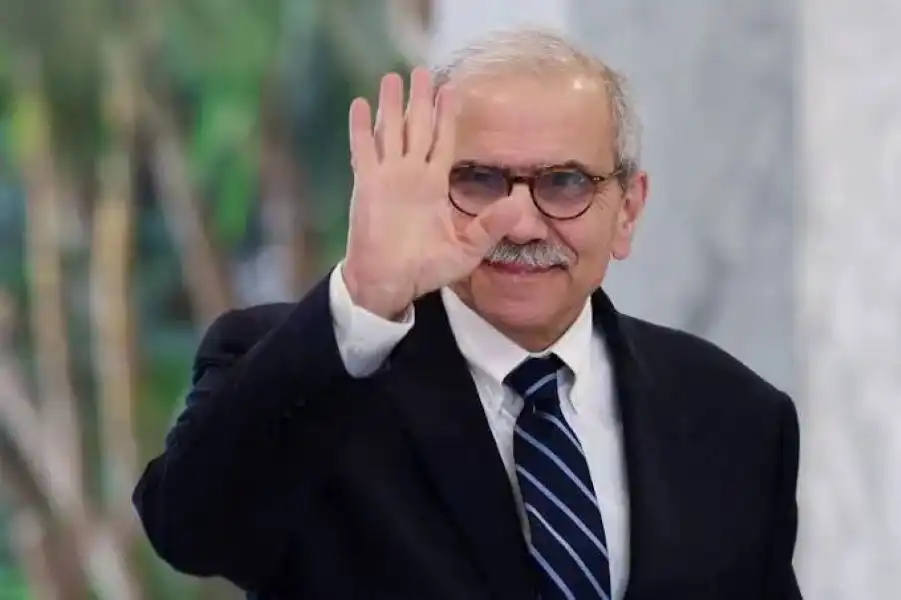لماذا تستمرّ الحروب رغم الحضارة والديمقراطية؟

إذا كان ثمّة ثابتٌ واحد في التاريخ البشري، فهو الحرب. تغيّرت الأزمنة، وتبدّلت الحضارات، وانهارت إمبراطوريات، واندثرت شعوب، لكن الحرب بقيت حاضرة، بأشكال مختلفة وأدوات متحوّلة، وكأنها جزء بنيويّ من المسار الإنساني. فمنذ التاريخ القديم، مرورًا بالعصور الوسطى، وصولًا إلى التاريخ الحديث والمعاصر، لم تعرف البشرية مرحلة خالية من الصّراعات المسلّحة.
لطالما ساد اعتقاد أن الحروب كانت نتاج عصور بدائيّة، حيث لم تكن هناك دول بالمعنى الحديث، ولا حدود مرسومة، ولا منظومات قانونية ناظمة للعلاقات بين الكيانات السياسية. في تلك المراحل، كان الجشع إلى السلطة، والرغبة في التوسّع، والسّعي إلى الثروة، تدفع القبائل والممالك والإمبراطوريّات إلى الغزو والاحتلال وفرض النفوذ. وكان يُفترض تراجُع هذه الظواهر مع نشوء الدولة الحديثة.
غير أن هذا الاعتقاد سرعان ما تهاوى. فبعد الحربين العالميّتين الأولى والثانية، وما خلّفتاه من دمار شامل ومآسٍ إنسانية غير مسبوقة، جرى رسم حدود الدول، وإنشاء منظومة دولية جديدة، وولدت شرعة حقوق الإنسان، وتأسّس مجلس الأمن الدولي بوصفه ضابطًا للنظام العالمي وحارسًا للسلم والأمن الدوليين. ومع ذلك، لم تتوقف الحروب، بل استمرّت بأشكال مختلفة، أحيانًا مباشرة وأحيانًا بالوكالة.
وهنا يبرز السؤال الجوهري: لماذا تستمرّ الحروب رغم دخول البشرية عصر الحداثة، ورغم انتشار الديمقراطية، ورغم الثورة التكنولوجية، وتحوّل العالم إلى ما يشبه “قرية كونية” مترابطة المصالح؟
الانطباع الشائع يربط بين الفقر والحرب، ويفترض أن تحسين شروط العيش والتنمية الاقتصادية يؤدّيان تلقائيًا إلى تراجع النزاعات. كما يفترض أن وجود مجلس الأمن ومنظومة القانون الدولي يشكّلان رادعًا كافيًا لمنع الصراعات. إلّا أن الوقائع أثبتت أن هذه المقاربة قاصرة، بل مضلِّلة في أحيان كثيرة.
فالخطأ الأوّل يكمن في الافتراض أن العالم بات متجانسًا من حيث مستوى التطوّر والحداثة. والحقيقة أن هذا غير صحيح على الإطلاق. فلم تدخل دول العالم كلّها فعليًا عصر الحداثة السياسية. فثمة دول ما زالت تعيش، في بنيتها الذهنية والسياسية، في زمن ما قبل الدولة الحديثة، أو في منطق القرن التاسع عشر، حيث القوة هي مصدر الشرعية، والتوسّع هو معيار العظمة.
يمكن، من دون تردّد، الإشارة إلى نماذج واضحة: روسيا، الصين، كوريا الشمالية، إيران، وفنزويلا في عهد تشافيز ومادورو. هذه الدول وغيرها، رغم امتلاك بعضها أدوات تكنولوجية متقدّمة، لا تتبنى فلسفة سياسية حديثة قوامها الإنسان وحقوقه، بل تحكمها عقائد قومية أو أيديولوجية أو ثورية ترى في الصراع وسيلة مشروعة ودائمة لفرض النفوذ وإعادة تشكيل العالم.
في هذه الأنظمة، لا تُعتبر الديمقراطية قيمة، ولا يُنظر إلى الإنسان كغاية، بل كأداة. الأولويّة ليست للرفاه أو الحريات أو الاستقرار أو نمط الحياة، بل للصراع، وتصدير الأزمات، وخلق الفوضى، وتوسيع مناطق النفوذ. من هنا، تصبح الحرب خيارًا بنيويًّا لا استثنائيًّا.
إيران، على سبيل المثال، ليست مجرّد دولة ذات مصالح تقليدية، بل هي مشروع توسّعي عابر للحدود، يقوم على تصدير الثورة، واستخدام الميليشيات، وزعزعة الاستقرار في الإقليم والعالم. وروسيا تعيد إحياء منطق الإمبراطورية بالقوّة. والصين، وإن اختلفت أدواتها، تتعامل مع النظام الدولي بمنطق الهيمنة لا الشراكة.
إلى جانب هذه العوامل الأيديولوجية، لا يمكن إغفال مصالح الدول الكبرى، وسعيها الدائم إلى تعزيز مكاسبها الاقتصادية والاستراتيجية. فالتكنولوجيا لم تُلغِ منطق القوّة، بل جعلته أكثر تعقيدًا. والحداثة لم تُنهِ الصراع، بل نقلته من ساحة إلى أخرى.
من هنا، يصبح استمرار الحروب أمرًا متوقعًا، لا استثنائيًا. فطالما أن العالم يضمّ دولًا لا تؤمن بالديمقراطية، ولا تجعل الإنسان في صلب أولويّاتها، ولا تقيم وزنًا لنوعية الحياة، وطالما أن أنماطًا سياسية قديمة ما زالت تتحكّم بقرارات دول تمتلك أدوات حديثة، فإن الحروب ستبقى جزءًا من المشهد الدولي.
الخلاصة أن الحرب ليست قدرًا بيولوجيًا ملازمًا للإنسان، لكنها نتيجة مباشرة لغياب الحداثة السياسية الحقيقية. وقبل أن تتحوّل كلّ الدول إلى ديمقراطيات، وقبل أن يصبح الإنسان القيمة العليا في السياسات العامة، وقبل أن يصبح نمط العيش هو الأساس، يجب توقع استمرار الحروب، مهما بلغت البشرية من تطوّر تقنيّ أو علميّ.
لماذا تستمرّ الحروب رغم الحضارة والديمقراطية؟

إذا كان ثمّة ثابتٌ واحد في التاريخ البشري، فهو الحرب. تغيّرت الأزمنة، وتبدّلت الحضارات، وانهارت إمبراطوريات، واندثرت شعوب، لكن الحرب بقيت حاضرة، بأشكال مختلفة وأدوات متحوّلة، وكأنها جزء بنيويّ من المسار الإنساني. فمنذ التاريخ القديم، مرورًا بالعصور الوسطى، وصولًا إلى التاريخ الحديث والمعاصر، لم تعرف البشرية مرحلة خالية من الصّراعات المسلّحة.
لطالما ساد اعتقاد أن الحروب كانت نتاج عصور بدائيّة، حيث لم تكن هناك دول بالمعنى الحديث، ولا حدود مرسومة، ولا منظومات قانونية ناظمة للعلاقات بين الكيانات السياسية. في تلك المراحل، كان الجشع إلى السلطة، والرغبة في التوسّع، والسّعي إلى الثروة، تدفع القبائل والممالك والإمبراطوريّات إلى الغزو والاحتلال وفرض النفوذ. وكان يُفترض تراجُع هذه الظواهر مع نشوء الدولة الحديثة.
غير أن هذا الاعتقاد سرعان ما تهاوى. فبعد الحربين العالميّتين الأولى والثانية، وما خلّفتاه من دمار شامل ومآسٍ إنسانية غير مسبوقة، جرى رسم حدود الدول، وإنشاء منظومة دولية جديدة، وولدت شرعة حقوق الإنسان، وتأسّس مجلس الأمن الدولي بوصفه ضابطًا للنظام العالمي وحارسًا للسلم والأمن الدوليين. ومع ذلك، لم تتوقف الحروب، بل استمرّت بأشكال مختلفة، أحيانًا مباشرة وأحيانًا بالوكالة.
وهنا يبرز السؤال الجوهري: لماذا تستمرّ الحروب رغم دخول البشرية عصر الحداثة، ورغم انتشار الديمقراطية، ورغم الثورة التكنولوجية، وتحوّل العالم إلى ما يشبه “قرية كونية” مترابطة المصالح؟
الانطباع الشائع يربط بين الفقر والحرب، ويفترض أن تحسين شروط العيش والتنمية الاقتصادية يؤدّيان تلقائيًا إلى تراجع النزاعات. كما يفترض أن وجود مجلس الأمن ومنظومة القانون الدولي يشكّلان رادعًا كافيًا لمنع الصراعات. إلّا أن الوقائع أثبتت أن هذه المقاربة قاصرة، بل مضلِّلة في أحيان كثيرة.
فالخطأ الأوّل يكمن في الافتراض أن العالم بات متجانسًا من حيث مستوى التطوّر والحداثة. والحقيقة أن هذا غير صحيح على الإطلاق. فلم تدخل دول العالم كلّها فعليًا عصر الحداثة السياسية. فثمة دول ما زالت تعيش، في بنيتها الذهنية والسياسية، في زمن ما قبل الدولة الحديثة، أو في منطق القرن التاسع عشر، حيث القوة هي مصدر الشرعية، والتوسّع هو معيار العظمة.
يمكن، من دون تردّد، الإشارة إلى نماذج واضحة: روسيا، الصين، كوريا الشمالية، إيران، وفنزويلا في عهد تشافيز ومادورو. هذه الدول وغيرها، رغم امتلاك بعضها أدوات تكنولوجية متقدّمة، لا تتبنى فلسفة سياسية حديثة قوامها الإنسان وحقوقه، بل تحكمها عقائد قومية أو أيديولوجية أو ثورية ترى في الصراع وسيلة مشروعة ودائمة لفرض النفوذ وإعادة تشكيل العالم.
في هذه الأنظمة، لا تُعتبر الديمقراطية قيمة، ولا يُنظر إلى الإنسان كغاية، بل كأداة. الأولويّة ليست للرفاه أو الحريات أو الاستقرار أو نمط الحياة، بل للصراع، وتصدير الأزمات، وخلق الفوضى، وتوسيع مناطق النفوذ. من هنا، تصبح الحرب خيارًا بنيويًّا لا استثنائيًّا.
إيران، على سبيل المثال، ليست مجرّد دولة ذات مصالح تقليدية، بل هي مشروع توسّعي عابر للحدود، يقوم على تصدير الثورة، واستخدام الميليشيات، وزعزعة الاستقرار في الإقليم والعالم. وروسيا تعيد إحياء منطق الإمبراطورية بالقوّة. والصين، وإن اختلفت أدواتها، تتعامل مع النظام الدولي بمنطق الهيمنة لا الشراكة.
إلى جانب هذه العوامل الأيديولوجية، لا يمكن إغفال مصالح الدول الكبرى، وسعيها الدائم إلى تعزيز مكاسبها الاقتصادية والاستراتيجية. فالتكنولوجيا لم تُلغِ منطق القوّة، بل جعلته أكثر تعقيدًا. والحداثة لم تُنهِ الصراع، بل نقلته من ساحة إلى أخرى.
من هنا، يصبح استمرار الحروب أمرًا متوقعًا، لا استثنائيًا. فطالما أن العالم يضمّ دولًا لا تؤمن بالديمقراطية، ولا تجعل الإنسان في صلب أولويّاتها، ولا تقيم وزنًا لنوعية الحياة، وطالما أن أنماطًا سياسية قديمة ما زالت تتحكّم بقرارات دول تمتلك أدوات حديثة، فإن الحروب ستبقى جزءًا من المشهد الدولي.
الخلاصة أن الحرب ليست قدرًا بيولوجيًا ملازمًا للإنسان، لكنها نتيجة مباشرة لغياب الحداثة السياسية الحقيقية. وقبل أن تتحوّل كلّ الدول إلى ديمقراطيات، وقبل أن يصبح الإنسان القيمة العليا في السياسات العامة، وقبل أن يصبح نمط العيش هو الأساس، يجب توقع استمرار الحروب، مهما بلغت البشرية من تطوّر تقنيّ أو علميّ.