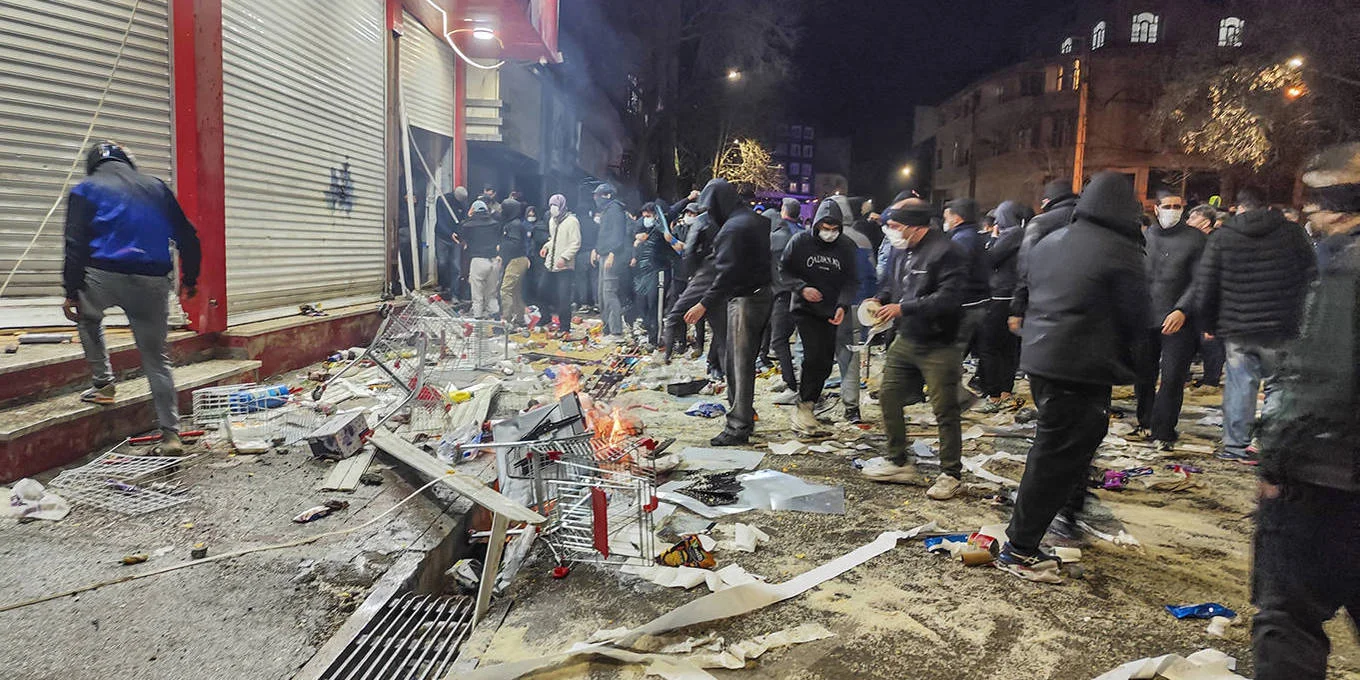هل يقلب حاكم مصرف لبنان الطاولة على المنظومة؟

رفض مقاربة تبحث عن كبش فداء بدل البحث عن نظام متكامل لتوزيع الخسائر بعدالة ومحاسبة المسؤولين الحقيقيين عنها
ما لا تستطيع هذه الحملات إخفاءه هو الموقف السياسي الواضح لرئيس الجمهورية. دعم صريح للحاكم، غطاء كامل لتحركه، وتأكيد علني أن لا حماية لأحد، وأن مكافحة الفساد ليست شعاراً ظرفياً بل مسار يجب أن يُستكمل حتى النهاية، وأن لا تراجع أمام الضغوط مهما كان مصدرها أو حجمها. هذا الموقف، بحد ذاته، كسر تقليداً طويلاً من المواربة، وأعاد الاعتبار لفكرة أن الدولة يمكن أن تحمي من يطبق القانون، لا من يخرقه.
منذ اللحظة التي قرر فيها حاكم مصرف لبنان كسر المحرمات وفتح الصندوق الأسود للمرحلة النقدية السابقة، خرجت المنظومة عن طورها. فجأة، تحول الرجل من مسؤول تقني يفترض به إدارة أزمة إلى هدف مباشر لحملة تحريض وتشويه غير مسبوقة، متعددة المنابر، واضحة الهدف. لم يكن ما تلا مؤتمره الصحافي الأول اختلافاً في الرأي أو نقاشاً مشروعاً حول السياسات النقدية، بل هجوماً مفتوحاً تقوده شبكات سياسية ومالية وإعلامية اعتادت لعقود أن تكون فوق المحاسبة، ووجدت نفسها أمام سابقة خطرة، مسؤول يتحرك بالقانون لا بالتوازنات.
الهجوم لم يأت من فراغ. فتح ملفات قانونية حساسة بحق مسؤولين كبار سابقين، ومصرفيين نافذين، وإداريين لعبوا أدواراً مركزية في إدارة المال العام، شكل تهديداً مباشراً لمنظومة كاملة بنيت على الحصانات. فجأة، لم يعد مصرف لبنان خزنة مفتوحة لتمويل العجز، ولا مظلة لتغطية السياسات الفاشلة، ولا أداة تستخدم كلما احتاجت السلطة إلى شراء الوقت. للمرة الأولى، قيل بوضوح إن أموال المصرف المركزي ليست ملكاً لأحد، وإن استردادها ليس خياراً سياسياً بل واجب قانوني، وإن هذه الأموال، عند استعادتها، تعود حكماً إلى المودعين لا إلى الدولة ولا إلى أية سلطة.
هنا تحديداً بدأ الذعر. بدل مواجهة الوقائع، تحركت ماكينة التضليل. وجوه إعلامية ومعلقون ومدونون وسياسيون سابقون خرجوا فجأة للدفاع عن مرحلة كانوا جزءاً من تبريرها أو الاستفادة منها. الهدف كان واحداً، ضرب نية المصرف المركزي المعلنة في خوض معركة استرداد الأموال المختلسة، وتخويف الحاكم، أو دفعه إلى تسوية تقفل الملفات قبل أن تصل إلى خواتيمها القضائية.
القضية التي كشفت أخيراً، والمتعلقة بإساءة استخدام المنصب من قبل مسؤولين سابقين وأحد كبار المصرفيين ضمن صفقات خاصة حققوا منها منافع شخصية، ليست تفصيلاً تقنياً ولا حادثة معزولة. التحقيقات القضائية في أكثر من دولة أوروبية كشفت شبكة معقدة من تحويلات مالية أعيد تدويرها في شراء عقارات بمئات ملايين اليوروهات، سجلت بأسماء أقارب وشركاء وشركات واجهة. الحديث هنا عن محافظ عقارية ضخمة، ومشاريع قيد التطوير تجاوزت قيمتها الإجمالية المليار، وأصول موزعة بين دول أوروبية وغربية عدة. هذه ليست شبهة سياسية، بل مسار موثق أمام القضاء.
أمام هذه الوقائع، لم تجد المنظومة ما تواجه به الحقيقة سوى حجة خبيثة وخطرة، الادعاء بأن الأموال المختلسة ليست أموال مصرف لبنان بل “أموال خاصة”. وكأن السرقة تصبح مقبولة إذا لم تكن من المصرف المركزي، أو كأن الاحتيال على المواطنين أقل جرماً من الاحتيال على الدولة. هذا المنطق، إذا قبل، لا يدمر فقط ما تبقى من فكرة المال العام، بل يشرع السرقة كخيار، ويحول النفوذ إلى رخصة إفلات دائم من العقاب.
لكن ما تتعمد هذه الحملات تجاهله هو حقيقة أساس لا يقوم اقتصاد من دونها، لا يمكن لأية دولة أن تنهض أو تستعيد ثقة الداخل والخارج من دون نظام مصرفي سليم. هذه ليست مسألة أيديولوجية ولا شعاراً إصلاحياً، بل قاعدة بنيوية في أي اقتصاد حديث. والنظام المصرفي السليم لا يولد بقرارات شكلية ولا بخطط ترحيل الخسائر، بل بمحاسبة واضحة وصريحة لارتكابات المرحلة الماضية. أي محاولة للقفز فوق هذه المحاسبة لا تؤسس لمرحلة جديدة، بل تمدد الانهيار بأدوات مختلفة.
ما قام به حاكم مصرف لبنان هو رسم هذا الحد الفاصل بوضوح غير مسبوق. لقد فصل بين الماضي والحاضر، لا بخطاب سياسي ولا بتسويق إعلامي، بل بفتح ملفات ووضع الحسابات السابقة تحت المجهر القضائي، وترسيم مسؤوليات كانت لأعوام محصنة. هذا الترسيم لم يكن انتقامياً ولا استعراضياً، بل شرط لازم لولادة نظام مصرفي جديد، صلب ومتماسك وقادر على التعافي. فالنظام الذي يدفن ماضيه بلا محاسبة يبقى رهينة له، ويعيد إنتاج أزماته مهما بدل الوجوه والعناوين.
في هذا السياق تحديداً، جاءت مواجهة الحاكم مع خطة الحكومة اللبنانية لما سمي “الفجوة المالية”. هذه الخطة، بصيغتها المطروحة، لا تعالج الأزمة بل تنقلها وتكدسها داخل النظام المصرفي، محملة المصارف وحدها كامل الخسائر، وكأن الدولة خارج المشهد، وكأن السياسات العامة والقرارات المالية والإنفاق غير المنضبط لم تكن أصل الانهيار. هذه المقاربة لا تؤدي إلى إصلاح، بل إلى إفلاس شامل للنظام المصرفي، مما يعني عملياً تدمير أي أفق لتعافٍ اقتصادي، وضرب ما تبقى من قدرة على الائتمان والاستثمار والنمو.
اعتراض الحاكم على هذه الخطة لم يكن دفاعاً عن المصارف كجسم، بل دفاعاً عن منطق اقتصادي سليم. إفلاس النظام المصرفي لا “يعاقب المصارف”، بل يطيح الاقتصاد كله، ويحول البلد إلى مساحة مالية مشلولة بلا تمويل وبلا استثمار وبلا دورة اقتصادية طبيعية. من هنا، شكل موقفه قلباً للطاولة على مقاربة كاملة سادت بعد الانهيار، مقاربة تبحث عن كبش فداء بدل البحث عن نظام متكامل لتوزيع الخسائر بعدالة ومحاسبة المسؤولين الحقيقيين عنها.
في موازاة ذلك، حاولت الحملات الإعلامية تسويق رواية مفادها أن الحاكم “يحضر نفسه لدور سياسي” أو “يطمع بمنصب”. هذه الرواية تسقط عند أول اختبار منطقي. من يريد منصباً في لبنان لا يفتح ملفات المنظومة، ولا يصطدم بشبكات المال، ولا يقطع خطوط التمويل، ولا يتحمل كلفة سياسية وإعلامية بهذا الحجم. السياسة في هذا البلد تدار بالتسويات لا بالمواجهات، وبالتحالفات لا بالمحاسبة. ما قام به الحاكم هو نقيض هذا المسار تماماً، وهو ما يفسر الهجوم عليه لا العكس.
الأزمة في جوهرها ليست مالية فحسب، بل أزمة رواية. بعد الـ17 من أكتوبر (تشرين الأول) 2019، لم يترك اللبنانيون يواجهون الحقيقة، بل فرضت عليهم سردية جاهزة، المصارف وحدها مسؤولة والدولة ضحية، والسياسات العامة خارج النقاش. هكذا جرى طمس عقود من الاستدانة غير المنضبطة، ونظام سياسي حول الدين العام إلى أسلوب حكم، ومصرف مركزي استخدم لتسهيل هذا النهج، ومصارف وجدت في العوائد السهلة بديلاً عن أي اقتصاد منتج. وعندما وقع الانهيار، تبرأت المنظومة من خياراتها، وقدمت كبش فداء واحداً، متناسيةً أنها هي من وفر الغطاء والتمديد والحماية.
الهجوم لم يقتصر على التشويه، بل تمدد إلى التجهيل المتعمد. معلقون تلفزيونيون بلا أية معرفة جدية بالقانون النقدي أو المصرفي يجزمون أمام آلاف المشاهدين بأن الحاكم تجاوز صلاحياته، متجاهلين نصوصاً واضحة تمنحه وحده حق مناقشة أي تشريع أو تنظيم مالي مع الحكومة. في أية دولة طبيعية، يحاسب هذا النوع من الدجل. في لبنان، يكافأ بالمنابر.
الأخطر من ذلك هو النظام البيئي الذي يحرس الكذب. صحافيون مزيفون، ومؤثرون للإيجار، وحسابات وهمية، ونجوم منصات، يبيعون السرديات كما تباع السلع، ويحولون النقاش العام إلى ضجيج بلا مضمون. هؤلاء لا يسرقون المال فحسب، بل يسرقون الحقيقة، ويمنعون أية محاسبة قبل أن تبدأ.
في المقابل، ما لا تستطيع هذه الحملات إخفاءه هو الموقف السياسي الواضح لرئيس الجمهورية. دعم صريح للحاكم وغطاء كامل لتحركه وتأكيد علني أن لا حماية لأحد، وأن مكافحة الفساد ليست شعاراً ظرفياً بل مسار يجب أن يستكمل حتى النهاية، وأن لا تراجع أمام الضغوط مهما كان مصدرها أو حجمها. هذا الموقف، بحد ذاته، كسر تقليداً طويلاً من المواربة، وأعاد الاعتبار لفكرة أن الدولة يمكن أن تحمي من يطبق القانون، لا من يخرقه.
ما يجري اليوم ليس معركة شخص بل اختبار حاسم للدولة. إما أن يستكمل فتح الصندوق الأسود وتبنى مرحلة جديدة على المحاسبة ونظام مصرفي سليم وقابل للحياة، وإما أن تقفل الحقيقة مجدداً ويُعاد إنتاج المنظومة نفسها بوجوه جديدة. في لبنان، الحقيقة عملة نادرة. ومن يخاف منها، هو وحده من يعرف حجم ما أخفاه داخل الخزنة.
هل يقلب حاكم مصرف لبنان الطاولة على المنظومة؟

رفض مقاربة تبحث عن كبش فداء بدل البحث عن نظام متكامل لتوزيع الخسائر بعدالة ومحاسبة المسؤولين الحقيقيين عنها
ما لا تستطيع هذه الحملات إخفاءه هو الموقف السياسي الواضح لرئيس الجمهورية. دعم صريح للحاكم، غطاء كامل لتحركه، وتأكيد علني أن لا حماية لأحد، وأن مكافحة الفساد ليست شعاراً ظرفياً بل مسار يجب أن يُستكمل حتى النهاية، وأن لا تراجع أمام الضغوط مهما كان مصدرها أو حجمها. هذا الموقف، بحد ذاته، كسر تقليداً طويلاً من المواربة، وأعاد الاعتبار لفكرة أن الدولة يمكن أن تحمي من يطبق القانون، لا من يخرقه.
منذ اللحظة التي قرر فيها حاكم مصرف لبنان كسر المحرمات وفتح الصندوق الأسود للمرحلة النقدية السابقة، خرجت المنظومة عن طورها. فجأة، تحول الرجل من مسؤول تقني يفترض به إدارة أزمة إلى هدف مباشر لحملة تحريض وتشويه غير مسبوقة، متعددة المنابر، واضحة الهدف. لم يكن ما تلا مؤتمره الصحافي الأول اختلافاً في الرأي أو نقاشاً مشروعاً حول السياسات النقدية، بل هجوماً مفتوحاً تقوده شبكات سياسية ومالية وإعلامية اعتادت لعقود أن تكون فوق المحاسبة، ووجدت نفسها أمام سابقة خطرة، مسؤول يتحرك بالقانون لا بالتوازنات.
الهجوم لم يأت من فراغ. فتح ملفات قانونية حساسة بحق مسؤولين كبار سابقين، ومصرفيين نافذين، وإداريين لعبوا أدواراً مركزية في إدارة المال العام، شكل تهديداً مباشراً لمنظومة كاملة بنيت على الحصانات. فجأة، لم يعد مصرف لبنان خزنة مفتوحة لتمويل العجز، ولا مظلة لتغطية السياسات الفاشلة، ولا أداة تستخدم كلما احتاجت السلطة إلى شراء الوقت. للمرة الأولى، قيل بوضوح إن أموال المصرف المركزي ليست ملكاً لأحد، وإن استردادها ليس خياراً سياسياً بل واجب قانوني، وإن هذه الأموال، عند استعادتها، تعود حكماً إلى المودعين لا إلى الدولة ولا إلى أية سلطة.
هنا تحديداً بدأ الذعر. بدل مواجهة الوقائع، تحركت ماكينة التضليل. وجوه إعلامية ومعلقون ومدونون وسياسيون سابقون خرجوا فجأة للدفاع عن مرحلة كانوا جزءاً من تبريرها أو الاستفادة منها. الهدف كان واحداً، ضرب نية المصرف المركزي المعلنة في خوض معركة استرداد الأموال المختلسة، وتخويف الحاكم، أو دفعه إلى تسوية تقفل الملفات قبل أن تصل إلى خواتيمها القضائية.
القضية التي كشفت أخيراً، والمتعلقة بإساءة استخدام المنصب من قبل مسؤولين سابقين وأحد كبار المصرفيين ضمن صفقات خاصة حققوا منها منافع شخصية، ليست تفصيلاً تقنياً ولا حادثة معزولة. التحقيقات القضائية في أكثر من دولة أوروبية كشفت شبكة معقدة من تحويلات مالية أعيد تدويرها في شراء عقارات بمئات ملايين اليوروهات، سجلت بأسماء أقارب وشركاء وشركات واجهة. الحديث هنا عن محافظ عقارية ضخمة، ومشاريع قيد التطوير تجاوزت قيمتها الإجمالية المليار، وأصول موزعة بين دول أوروبية وغربية عدة. هذه ليست شبهة سياسية، بل مسار موثق أمام القضاء.
أمام هذه الوقائع، لم تجد المنظومة ما تواجه به الحقيقة سوى حجة خبيثة وخطرة، الادعاء بأن الأموال المختلسة ليست أموال مصرف لبنان بل “أموال خاصة”. وكأن السرقة تصبح مقبولة إذا لم تكن من المصرف المركزي، أو كأن الاحتيال على المواطنين أقل جرماً من الاحتيال على الدولة. هذا المنطق، إذا قبل، لا يدمر فقط ما تبقى من فكرة المال العام، بل يشرع السرقة كخيار، ويحول النفوذ إلى رخصة إفلات دائم من العقاب.
لكن ما تتعمد هذه الحملات تجاهله هو حقيقة أساس لا يقوم اقتصاد من دونها، لا يمكن لأية دولة أن تنهض أو تستعيد ثقة الداخل والخارج من دون نظام مصرفي سليم. هذه ليست مسألة أيديولوجية ولا شعاراً إصلاحياً، بل قاعدة بنيوية في أي اقتصاد حديث. والنظام المصرفي السليم لا يولد بقرارات شكلية ولا بخطط ترحيل الخسائر، بل بمحاسبة واضحة وصريحة لارتكابات المرحلة الماضية. أي محاولة للقفز فوق هذه المحاسبة لا تؤسس لمرحلة جديدة، بل تمدد الانهيار بأدوات مختلفة.
ما قام به حاكم مصرف لبنان هو رسم هذا الحد الفاصل بوضوح غير مسبوق. لقد فصل بين الماضي والحاضر، لا بخطاب سياسي ولا بتسويق إعلامي، بل بفتح ملفات ووضع الحسابات السابقة تحت المجهر القضائي، وترسيم مسؤوليات كانت لأعوام محصنة. هذا الترسيم لم يكن انتقامياً ولا استعراضياً، بل شرط لازم لولادة نظام مصرفي جديد، صلب ومتماسك وقادر على التعافي. فالنظام الذي يدفن ماضيه بلا محاسبة يبقى رهينة له، ويعيد إنتاج أزماته مهما بدل الوجوه والعناوين.
في هذا السياق تحديداً، جاءت مواجهة الحاكم مع خطة الحكومة اللبنانية لما سمي “الفجوة المالية”. هذه الخطة، بصيغتها المطروحة، لا تعالج الأزمة بل تنقلها وتكدسها داخل النظام المصرفي، محملة المصارف وحدها كامل الخسائر، وكأن الدولة خارج المشهد، وكأن السياسات العامة والقرارات المالية والإنفاق غير المنضبط لم تكن أصل الانهيار. هذه المقاربة لا تؤدي إلى إصلاح، بل إلى إفلاس شامل للنظام المصرفي، مما يعني عملياً تدمير أي أفق لتعافٍ اقتصادي، وضرب ما تبقى من قدرة على الائتمان والاستثمار والنمو.
اعتراض الحاكم على هذه الخطة لم يكن دفاعاً عن المصارف كجسم، بل دفاعاً عن منطق اقتصادي سليم. إفلاس النظام المصرفي لا “يعاقب المصارف”، بل يطيح الاقتصاد كله، ويحول البلد إلى مساحة مالية مشلولة بلا تمويل وبلا استثمار وبلا دورة اقتصادية طبيعية. من هنا، شكل موقفه قلباً للطاولة على مقاربة كاملة سادت بعد الانهيار، مقاربة تبحث عن كبش فداء بدل البحث عن نظام متكامل لتوزيع الخسائر بعدالة ومحاسبة المسؤولين الحقيقيين عنها.
في موازاة ذلك، حاولت الحملات الإعلامية تسويق رواية مفادها أن الحاكم “يحضر نفسه لدور سياسي” أو “يطمع بمنصب”. هذه الرواية تسقط عند أول اختبار منطقي. من يريد منصباً في لبنان لا يفتح ملفات المنظومة، ولا يصطدم بشبكات المال، ولا يقطع خطوط التمويل، ولا يتحمل كلفة سياسية وإعلامية بهذا الحجم. السياسة في هذا البلد تدار بالتسويات لا بالمواجهات، وبالتحالفات لا بالمحاسبة. ما قام به الحاكم هو نقيض هذا المسار تماماً، وهو ما يفسر الهجوم عليه لا العكس.
الأزمة في جوهرها ليست مالية فحسب، بل أزمة رواية. بعد الـ17 من أكتوبر (تشرين الأول) 2019، لم يترك اللبنانيون يواجهون الحقيقة، بل فرضت عليهم سردية جاهزة، المصارف وحدها مسؤولة والدولة ضحية، والسياسات العامة خارج النقاش. هكذا جرى طمس عقود من الاستدانة غير المنضبطة، ونظام سياسي حول الدين العام إلى أسلوب حكم، ومصرف مركزي استخدم لتسهيل هذا النهج، ومصارف وجدت في العوائد السهلة بديلاً عن أي اقتصاد منتج. وعندما وقع الانهيار، تبرأت المنظومة من خياراتها، وقدمت كبش فداء واحداً، متناسيةً أنها هي من وفر الغطاء والتمديد والحماية.
الهجوم لم يقتصر على التشويه، بل تمدد إلى التجهيل المتعمد. معلقون تلفزيونيون بلا أية معرفة جدية بالقانون النقدي أو المصرفي يجزمون أمام آلاف المشاهدين بأن الحاكم تجاوز صلاحياته، متجاهلين نصوصاً واضحة تمنحه وحده حق مناقشة أي تشريع أو تنظيم مالي مع الحكومة. في أية دولة طبيعية، يحاسب هذا النوع من الدجل. في لبنان، يكافأ بالمنابر.
الأخطر من ذلك هو النظام البيئي الذي يحرس الكذب. صحافيون مزيفون، ومؤثرون للإيجار، وحسابات وهمية، ونجوم منصات، يبيعون السرديات كما تباع السلع، ويحولون النقاش العام إلى ضجيج بلا مضمون. هؤلاء لا يسرقون المال فحسب، بل يسرقون الحقيقة، ويمنعون أية محاسبة قبل أن تبدأ.
في المقابل، ما لا تستطيع هذه الحملات إخفاءه هو الموقف السياسي الواضح لرئيس الجمهورية. دعم صريح للحاكم وغطاء كامل لتحركه وتأكيد علني أن لا حماية لأحد، وأن مكافحة الفساد ليست شعاراً ظرفياً بل مسار يجب أن يستكمل حتى النهاية، وأن لا تراجع أمام الضغوط مهما كان مصدرها أو حجمها. هذا الموقف، بحد ذاته، كسر تقليداً طويلاً من المواربة، وأعاد الاعتبار لفكرة أن الدولة يمكن أن تحمي من يطبق القانون، لا من يخرقه.
ما يجري اليوم ليس معركة شخص بل اختبار حاسم للدولة. إما أن يستكمل فتح الصندوق الأسود وتبنى مرحلة جديدة على المحاسبة ونظام مصرفي سليم وقابل للحياة، وإما أن تقفل الحقيقة مجدداً ويُعاد إنتاج المنظومة نفسها بوجوه جديدة. في لبنان، الحقيقة عملة نادرة. ومن يخاف منها، هو وحده من يعرف حجم ما أخفاه داخل الخزنة.