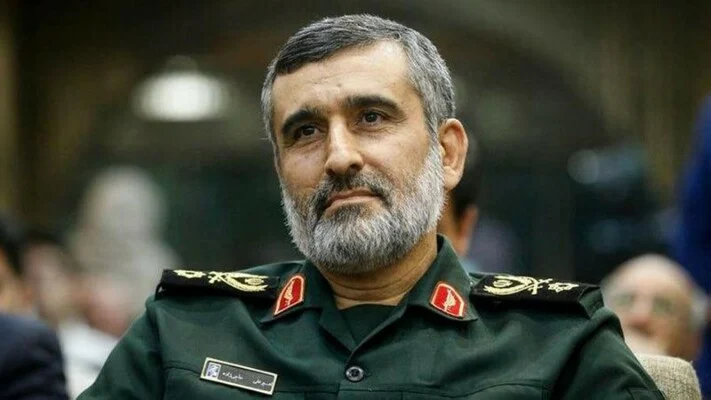لماذا استهداف المغتربين؟

في بلدٍ تهجّر منه أكثر من نصف أبنائه على مراحل متلاحقة، بدءًا بأحداث السبعينات وصولًا إلى الانهيار الراهن، ما زال حق اللبنانيين المغتربين في التصويت يُعامَل كامتياز مشروط لا كحق مكتمل. والسؤال الطبيعي الذي يفرض نفسه: لماذا تُفرَض كلّ هذه العراقيل أمام إشراك اللبنانيين في الخارج في الانتخابات النيابية، رغم أنهم يشكّلون ركنًا أساسيًا من القوّة الوطنية والاقتصادية والسياسية للبنان؟
هذا الملف لم يعد تفصيلًا تقنيًا في قانون الانتخاب، بل بات معيارًا يكشف مدى صدقية الدولة وقدرتها على تمثيل مواطنيها أينما وُجدوا. فالمسألة تتجاوز حدود اللوجستيات والإجراءات لتطول جوهر السيادة والدستور، وتفضح بنية نظام سياسي يسعى جزء منه إلى احتكار القرار الوطني والتحكّم مسبقًا بمسار العملية الانتخابية.
التاريخ يؤكّد هذا النهج. ففي انتخابات 1943، التي سبقت الاستقلال، جرى منع نحو 120 ألف مغترب – كان معظمهم من الطوائف المسيحية – من الاقتراع خشية أي تعديل في التوازنات السياسية التي أرست السلطة الجديدة وحدّدت خيارات لبنان الاستراتيجية. هذا الإقصاء رسّخ ثقافة تقوم على ضبط الجسم الناخب لحماية موازين القوى.
وبعد ثمانية عقود، لا تزال المنظومة تعيد إنتاج الذهنية نفسها. فالإبقاء على المادة 122 من قانون الانتخاب، ورفض تعديل المادة 112 التي تضيّق على مشاركة المغتربين، ليسا تفصيلين قانونيين معزولين، بل تعبيرًا واضحًا عن رغبة في التحكّم بنتائج الاقتراع. فالسلطة تبحث دائمًا عن بيئة انتخابية يمكن السيطرة عليها: ناخب خاضع للحاجات اليومية وشبكات الخدمات، لا مغترب يصوّت وفق قناعاته المستقلّة.
وفي سياق سياسي تهيمن عليه قوى الأمر الواقع ويتقدّم فيه النفوذ على الدولة، يصبح تحجيم الصوت الاغترابي خيارًا استراتيجيًا. فالمغترب الذي يعيش في كندا أو أوروبا أو الخليج لا ينتظر خدمة من نائب، ولا يخشى انقطاع كهرباء، ولا يُبتز بوظيفة أو معاملة، ولا ينجرّ للتجييش الطائفي. ولذلك يُنظر إلى صوته كتهديد مباشر لمنظومة بنت نفوذها على التحكّم بالناخبين عبر الخوف والخدمات والزبائنية.
انتخابات 2022 كانت كاشفة: المغتربون صوّتوا بحرية كاملة وأسهموا في إيصال كتل سيادية وتغييرية كسرت جزءًا من الانسداد السياسي. سجّل 244 ألف لبناني في الخارج، اقترع منهم 142 ألفًا بنسبة 63 %، أي أعلى بكثير من نسبة المشاركة في الداخل. ولو فُتح التسجيل فعلًا، لبلغ عدد من يحق لهم التصويت أكثر من 1.3 مليون. هذه الأرقام وحدها كافية لتفسير حجم القلق داخل السلطة.
هنا يبرز دور السلطة التشريعية، وتحديدًا الدور الذي لعبه رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال العقود الثلاثة الماضية. فمنذ الطائف، تحوّل المجلس النيابي إلى مؤسسة تخضع عمليًا لإرادة سياسية واحدة: جلسات تُعطّل، قوانين تُدفن، انتخاب رئيس يُفرّغ، والنصوص الدستورية تُفسَّر وفق المصلحة لا وفق الدستور. المادة 73 مثلًا تلزمه بالدعوة إلى انتخاب رئيس قبل شهرين من انتهاء الولاية، لكنه عطّلها لسنوات بلا محاسبة.
هذا النهج انعكس على ملف تصويت المغتربين. فالدستور واضح: المادة 7 تضمن المساواة بين اللبنانيين، والمادة 21 تمنح كلّ مواطن بلغ السن القانونية حق الاقتراع من دون ربطه بالإقامة. وقانون الانتخاب – في مادته 112- يؤكد حق المغترب بالاقتراع للدائرة الأم، أي للـ 128 نائبًا. أما المادة 122 الخاصة بالنواب الستة فهي صيغة مؤجّلة التنفيذ، لا بديل عن التصويت الكامل.
ومع ذلك، استُخدمت ذريعة “عدم الجهوزية اللوجستية” في 2022 لتعطيل الحق، رغم جهوزية 48 دولة لاستقبال الناخبين، وتوفر الصناديق، والأقلام، وآليات الفرز الإلكتروني. ما كان مفقودًا ليس الاستعداد الإداري بل الإرادة السياسية. فصوت المغترب بات قادرًا على قلب نتائج دوائر حسّاسة لطالما اعتُبرت محسومة لصالح القوى التقليدية.
اللبنانيون في الخارج ليسوا رقمًا انتخابيًا إضافيًا ولا جمهورًا يُستحضر عند الحاجة. إنهم جزء من تكوين لبنان التاريخي والثقافي والاقتصادي، وامتداد طبيعي لدبلوماسيته وعلاقاته في العالم. وإقصاؤهم ليس مجرّد قرار إداري، بل هو دليل على أزمة سياسية عميقة ومحاولة مستمرّة لحماية منظومة فقدت شرعيتها الشعبية.
لماذا استهداف المغتربين؟

في بلدٍ تهجّر منه أكثر من نصف أبنائه على مراحل متلاحقة، بدءًا بأحداث السبعينات وصولًا إلى الانهيار الراهن، ما زال حق اللبنانيين المغتربين في التصويت يُعامَل كامتياز مشروط لا كحق مكتمل. والسؤال الطبيعي الذي يفرض نفسه: لماذا تُفرَض كلّ هذه العراقيل أمام إشراك اللبنانيين في الخارج في الانتخابات النيابية، رغم أنهم يشكّلون ركنًا أساسيًا من القوّة الوطنية والاقتصادية والسياسية للبنان؟
هذا الملف لم يعد تفصيلًا تقنيًا في قانون الانتخاب، بل بات معيارًا يكشف مدى صدقية الدولة وقدرتها على تمثيل مواطنيها أينما وُجدوا. فالمسألة تتجاوز حدود اللوجستيات والإجراءات لتطول جوهر السيادة والدستور، وتفضح بنية نظام سياسي يسعى جزء منه إلى احتكار القرار الوطني والتحكّم مسبقًا بمسار العملية الانتخابية.
التاريخ يؤكّد هذا النهج. ففي انتخابات 1943، التي سبقت الاستقلال، جرى منع نحو 120 ألف مغترب – كان معظمهم من الطوائف المسيحية – من الاقتراع خشية أي تعديل في التوازنات السياسية التي أرست السلطة الجديدة وحدّدت خيارات لبنان الاستراتيجية. هذا الإقصاء رسّخ ثقافة تقوم على ضبط الجسم الناخب لحماية موازين القوى.
وبعد ثمانية عقود، لا تزال المنظومة تعيد إنتاج الذهنية نفسها. فالإبقاء على المادة 122 من قانون الانتخاب، ورفض تعديل المادة 112 التي تضيّق على مشاركة المغتربين، ليسا تفصيلين قانونيين معزولين، بل تعبيرًا واضحًا عن رغبة في التحكّم بنتائج الاقتراع. فالسلطة تبحث دائمًا عن بيئة انتخابية يمكن السيطرة عليها: ناخب خاضع للحاجات اليومية وشبكات الخدمات، لا مغترب يصوّت وفق قناعاته المستقلّة.
وفي سياق سياسي تهيمن عليه قوى الأمر الواقع ويتقدّم فيه النفوذ على الدولة، يصبح تحجيم الصوت الاغترابي خيارًا استراتيجيًا. فالمغترب الذي يعيش في كندا أو أوروبا أو الخليج لا ينتظر خدمة من نائب، ولا يخشى انقطاع كهرباء، ولا يُبتز بوظيفة أو معاملة، ولا ينجرّ للتجييش الطائفي. ولذلك يُنظر إلى صوته كتهديد مباشر لمنظومة بنت نفوذها على التحكّم بالناخبين عبر الخوف والخدمات والزبائنية.
انتخابات 2022 كانت كاشفة: المغتربون صوّتوا بحرية كاملة وأسهموا في إيصال كتل سيادية وتغييرية كسرت جزءًا من الانسداد السياسي. سجّل 244 ألف لبناني في الخارج، اقترع منهم 142 ألفًا بنسبة 63 %، أي أعلى بكثير من نسبة المشاركة في الداخل. ولو فُتح التسجيل فعلًا، لبلغ عدد من يحق لهم التصويت أكثر من 1.3 مليون. هذه الأرقام وحدها كافية لتفسير حجم القلق داخل السلطة.
هنا يبرز دور السلطة التشريعية، وتحديدًا الدور الذي لعبه رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال العقود الثلاثة الماضية. فمنذ الطائف، تحوّل المجلس النيابي إلى مؤسسة تخضع عمليًا لإرادة سياسية واحدة: جلسات تُعطّل، قوانين تُدفن، انتخاب رئيس يُفرّغ، والنصوص الدستورية تُفسَّر وفق المصلحة لا وفق الدستور. المادة 73 مثلًا تلزمه بالدعوة إلى انتخاب رئيس قبل شهرين من انتهاء الولاية، لكنه عطّلها لسنوات بلا محاسبة.
هذا النهج انعكس على ملف تصويت المغتربين. فالدستور واضح: المادة 7 تضمن المساواة بين اللبنانيين، والمادة 21 تمنح كلّ مواطن بلغ السن القانونية حق الاقتراع من دون ربطه بالإقامة. وقانون الانتخاب – في مادته 112- يؤكد حق المغترب بالاقتراع للدائرة الأم، أي للـ 128 نائبًا. أما المادة 122 الخاصة بالنواب الستة فهي صيغة مؤجّلة التنفيذ، لا بديل عن التصويت الكامل.
ومع ذلك، استُخدمت ذريعة “عدم الجهوزية اللوجستية” في 2022 لتعطيل الحق، رغم جهوزية 48 دولة لاستقبال الناخبين، وتوفر الصناديق، والأقلام، وآليات الفرز الإلكتروني. ما كان مفقودًا ليس الاستعداد الإداري بل الإرادة السياسية. فصوت المغترب بات قادرًا على قلب نتائج دوائر حسّاسة لطالما اعتُبرت محسومة لصالح القوى التقليدية.
اللبنانيون في الخارج ليسوا رقمًا انتخابيًا إضافيًا ولا جمهورًا يُستحضر عند الحاجة. إنهم جزء من تكوين لبنان التاريخي والثقافي والاقتصادي، وامتداد طبيعي لدبلوماسيته وعلاقاته في العالم. وإقصاؤهم ليس مجرّد قرار إداري، بل هو دليل على أزمة سياسية عميقة ومحاولة مستمرّة لحماية منظومة فقدت شرعيتها الشعبية.